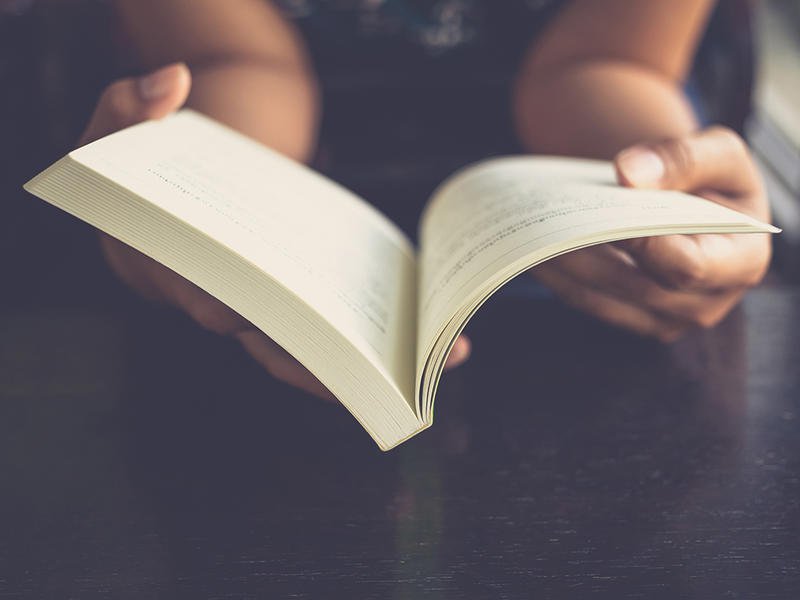يعود الروائي المغربي سعيد الشفاج، من جديد، ليعانق قراءه في عمل جديد ومختلف موسوم بـ«عشق الأميرات» عقب النجاح الذي عرفته روايته الذاتية الأولى «درب المعاكيز» التي أعطى فيها الحق للذات، وكأنه بذلك، أراد أن يصفي حسابا شخصيا سيكولوجيا مع مرحلة معينة مرت بحلوها ومرها، وتركت ندوبها في الأعماق، ويقطع مع فضاء «البرنوصي» الذي يسكن الذاكرة والوجدان.
وهذا فعلا ما تحصل للشفاج في تجربته الثانية، اذ أنه انطلق بعيدا بدون أن يلتفت للخلف، مصمما عالمه الروائي بإصرار وثبات، في استقلال تام عن الأفضية التي يسكنها وتسكنه، وبعيدا عن النماذج البشرية التي يصادفها في حياته اليومية، وفي انفصال تام عن الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه محولا وجهته نحو فضاء سهل دكالة، المتاخم للمحيط ووادي أم الربيع، وإن عاد للمدينة، فإنما يفعل ذلك لاعتبارات فنية وجمالية.
هذا وتصور الرواية مدى تفشي الخرافة في الأوساط المجتمعية، سواء في المدن أو القرى، وكيف ترسي العقلية المتخلفة هاته الثقافة بدعم من الجهات الرسمية التي ترعى هذا التوهم، وتحرص على أن يظل ساري المفعول تخديرا للمستضعفين، وإلهاء لهم عن النظر إلى موقع الجرح، والوعي بحقوقهم ومسؤولياتهم. وفي هذا السياق يتحول الرجل العادي محمد (بطل القصة)، المصاب جراء ما حصل له مع الأميرة المزعومة، إلى ولي صالح يقصده المهمومون والمرضى والموسوسون بحثا عن علاج سحري يصدر عنه بفعل البركة التي نزلت عليه من السماء، واختصته بهذه العطية «شفاء أسقام الناس الفقراء والمعوزين، وطرد النحس عنهم».
وحريّ بالذكر أن الشفاج يطرح في هذا العمل المفارقة الصارخة بين الوعي بالطقس الخرافي، واللاوعي به، يجعلهما معا يتجاذبان السجال بشكل عفوي، لكن وسيطا مزيفا كان بالمرصاد، تيار الوعي، ويمتلك القوة والسلطة، بحيث يقف حاجزا أو وقوع التواصل بين التيارين، مسخرا وسائله كلها في سبيل الإبقاء على التباعد بينهما، وتعرية واقع الزيف والبؤس اللذين يغلفان هذا الطقس، وفضح المستفيدين من ريعه وعائداته المستحلبة من جيوب الفقراء.